في 4 آب 2025، نُشر مقال لافت في موقع BAKU NETWORK، تناول أبعاد تراجع الولايات المتحدة بالتحليل والدراسة. وقد أُشير فيه إلى عوامل متعددة مثل تراجع القوة العسكرية، الضعف الاقتصادي، العجز عن إدارة التجارة، ضعف السيطرة على المجتمع والأزمات الداخلية، التخلي عن الحلفاء، بل وحتى الصدام مع القيم والمبادئ التي شكّلت ما سُمّي بـ”النظام الأمريكي” حيث اعتُبرت واشنطن الهيمنة الوحيدة والقوة العظمى العالمية. كما أشار الكاتب إلى صعود قوى ناشئة كالصين وروسيا وإيران كعوامل أساسية في هذا التحول.
النظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة الولايات المتحدة كان شاملاً ومسيطراً وطويلاً الأمد، لكن إشارات الخطر بدأت تلوح. النظام العالمي الذي بنته واشنطن أصيب بالشرخ وتعرض لانهيار بنيوي. السبب الرئيس لهذه الأزمة ليس الضغوط الخارجية فقط، بل الولايات المتحدة نفسها، خصوصاً مع رئاسة دونالد ترامب، الذي لم يكتفِ بإعادة كتابة قواعد السياسة العالمية، بل بدا وكأنه مستعد لإنهاء فصل “باكس أمريكانا”.
كل نظام يعكس في جوهره وضع القوة وهيكلها. منذ 1945 أعادت الولايات المتحدة تنظيم العالم: عبر إنشاء تحالفات عسكرية في القارات، تثبيت الدولار كعملة عالمية، تأسيس محاكم ومؤسسات دولية تحت إدارة الغرب، والترويج لـ”الديمقراطية” كنموذج حكم افتراضي. ما ثبّت هذا النظام لم يكن القوة الاقتصادية والعسكرية فحسب، بل الإيمان بأن أمريكا رمز العدالة والاستقرار والرفاه.
لكن هذا الإيمان يتلاشى بسرعة. ليس لأن العالم وجد بديلاً أفضل، بل لأن الحارس نفسه فقد إيمانه واستقراره. هناك ثلاث صدوع تهزّ أسس الهيمنة الأمريكية، وسقوط أي واحد منها يكفي لخلق كارثة.
1. الانهيار العسكري؛ فشل الردع العالمي
ما زالت الولايات المتحدة تملك أقوى جيش في العالم. لكن وهم عدم الهزيمة قد تلاشى. بعد إخفاقات أفغانستان والعراق، انهارت أسطورة القوة المطلقة لأمريكا. والآن، من تايوان إلى الشرق الأوسط، تقف واشنطن على أعتاب فقدان السيطرة.
أخطر نقطة هي تايوان. إن هجوم الصين لا يشعل حرباً إقليمية فحسب، بل يدمّر صورة أمريكا باعتبارها الضامن لأمن آسيا. وفي الخليج الفارسي أيضاً، فإن عجز واشنطن عن كبح إيران، إلى جانب التوترات المتصاعدة، يزعزع صورة قيادة أمريكا على طرق النفط العالمية. أما كوريا الشمالية، فبترسانتها النووية وضعت أمريكا اليوم في مقام ندٍّ لها وفرضت شروطها عليها.
هذا لم يعد عالم “باكس أمريكانا”؛ بل عالم الانقسام والتيه، حيث أصبحت القوى المراجِعة مثل الصين وروسيا وإيران أكثر جرأة. إن هزيمة عسكرية كبيرة للولايات المتحدة، خصوصاً في منطقة الإندو-باسيفيك (منطقة شاسعة تمتد من السواحل الغربية للهند إلى السواحل الغربية للولايات المتحدة)، يمكن أن تكون الشرارة التي تدمر تحالفات أمريكا وتدفع شركاء


2. الفخ الاقتصادي؛ الدولار يغرق في الديون
تعيش الولايات المتحدة على “المهل الاقتراضية” و”الأموال المقترضة”. لقد تجاوز الدين القومي 35 تريليون دولار، والموازنات الجديدة للحكومة تعمّق هذه الهوة أكثر فأكثر. ما زال الاحتياطي الفدرالي يطبع النقود، وما زالت الأسواق تعتبر الدولار ملكها، لكن هذا الثقة التاريخية لها تاريخ انتهاء.
إن القوة الاقتصادية لأمريكا قائمة على الطلب العالمي على الدولار. فطالما بقي الدولار عملة الاحتياط العالمي، تستطيع واشنطن الاستمرار رغم العجوزات، من دون عواقب خطيرة. لكن هذه الميزة في حالة تآكل. فدول مجموعة بريكس تبحث اليوم عن بدائل للنظام المالي الغربي، واقتصادات كبيرة مثل السعودية والهند والصين وتركيا تتجه أكثر فأكثر إلى التجارة بعملاتها الوطنية.
إن انهيار الثقة بالدولار لا يخلق أزمة مالية في الولايات المتحدة فحسب، بل يوقف أيضاً مسار العولمة. ففي الوقت الذي ما زالت فيه البنوك وصناديق الاستثمار والشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية تسيطر على جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن العجوزات المتزايدة، والهزات التضخمية، وتراجع التصنيفات الائتمانية ليست مجرد إشارات إنذار، بل هي الاهتزازات الأولية لزلزال بنيوي شامل


3. الانهيار الأيديولوجي؛ أمريكا لم تعد تؤمن بنفسها!
كانت القيادة العالمية دائماً أبعد من امتلاك الدبابات والتجارة القوية؛ فالقضية الأساسية هي الشرعية الأخلاقية. بعد الحرب العالمية الثانية، قدّمت الولايات المتحدة نفسها كمنارة للديمقراطية أمام العالم، لكن ذلك المصباح اليوم في طريقه إلى الانطفاء.
على الصعيد الداخلي، المجتمع الأمريكي ممزق. الاستقطاب السياسي، الاضطرابات الاجتماعية، والانهيار التاريخي للثقة بالمؤسسات أصاب الروح الجماعية الأمريكية بجراح وأدخلها في تيه وضياع. إن الهجوم على الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021 لم يكن مجرد جرح وطني، بل رمزاً عالمياً لانهيار أمريكا. فإذا كان قلب الديمقراطية الأمريكية هشّاً إلى هذا الحد، فكيف يمكنها أن تتوقع الحفاظ على شرعيتها خارج حدودها؟
إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ليست مجرد تغيير سياسي، بل هي إزاحة كاملة لبارادايم. فهو يهين المؤسسات الدولية، ويشكك في التحالفات القديمة، ولا يبدي أي استعداد للتضحية في سبيل الأمن الجماعي. أما شعاره “أمريكا أولاً”، فهو صفعة صريحة لمنطق القيادة العالمية الأمريكية. والرسالة لحلفاء أمريكا واضحة: لا تعوّلوا على واشنطن، لأن واشنطن لا تعوّل إلا على نفسها. العالم لم يعد يرى أمريكا عمود الاستقرار، بل مصدر الاضطراب.
ويُظهر التاريخ أن القوى العظمى نادراً ما تنهار على طاولة المفاوضات؛ بل تسقط بعد ضربة مصيرية في ميدان المعركة. أثينا انهارت بعد كارثة صقلية، نابليون دُمر في واترلو، والإمبراطورية البريطانية بدأت زوالها بعد “النصر المكلف” في الحرب العالمية الأولى. واليوم، هذا الشبح نفسه يخيّم على أمريكا؛ لا كفرضية نظرية، بل كخطر واقعي يتم وضع سيناريوهات له في البنتاغون وتناقشه الدوائر الدبلوماسية.
ستعراض القوة الصينية؛ الضربة التي تغيّر كل شيء!
ظهرت الولايات المتحدة خلال عقود ما بعد الحرب الباردة في دور “الشريف العالمي” بلا منازع. لكن عقد العشرينيات من القرن الحادي والعشرين حمل رسالة واضحة: قوة جديدة تنهض في آسيا؛ لا لتحدي أمريكا فقط، بل للاستعداد لمواجهة مباشرة.
إن الصين تبني آلة حربية مخصّصة للقرن الحادي والعشرين: مئات الصواريخ المتطورة، أسلحة فرط صوتية، بحرية تجاوزت أمريكا في عدد السفن، وترسانة نووية في توسّع مستمر؛ وكل ذلك لهدف واحد: مواجهة محتملة في مضيق تايوان. لم تعد بكين تخفي نواياها، فهدفها الاستراتيجي هو طرد أمريكا من غرب المحيط الهادئ، ولا تستبعد استخدام القوة لتحقيقه.
إن الحرب على تايوان قد تكون بمثابة “سراييفو” للقرن الحادي والعشرين، الشرارة التي تشعل حرباً عالمية. ستُجبر الولايات المتحدة على التدخل حفاظاً على مصداقيتها ودفاعاً عن حليفها، لكن نتيجة هذا التدخل ليست مضمونة. التهديدات المطروحة جسيمة: الجيش الصيني يتمتع بميزة القرب الجغرافي، والحجم الأكبر، والمساحة الأوسع. القواعد الأمريكية معرّضة للخطر، سلاسل الإمداد غير كافية، وحتى حلفاء واشنطن الإقليميون مترددون.
إذا خسرت أمريكا تلك الحرب، فلن تخسر معركة واحدة فقط؛ بل ستخسر معها هالة عدم الهزيمة، والتحالفات، والقواعد، والنفوذ، وإمكانية الوصول إلى المناطق المفصلية في العالم. وكما قال الأدميرال صامويل بابارو، قائد القوات الأمريكية في منطقة الإندو-باسيفيك: “إن أمريكا لا تزال تتصرف كأنها دولة خالدة، لكن الوقت ليس في صالحنا”.


تآكل الجيش الأمريكي في الحروب الشاملة
إن الجيش الأمريكي منتشر في العالم كله: أوكرانيا، الشرق الأوسط، كوريا، إفريقيا؛ وكل ساحة قتال تحتاج إلى اهتمام، وذخائر، ودعم لوجستي. لكن العمود الفقري للقوات المسلحة الأمريكية، المصممة أصلاً لمعارك محدودة، انحنى تحت وطأة الضغط العالمي.
نعم، تنفق أمريكا على دفاعها أكثر من أي دولة أخرى. لكن نسبة هذا الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي في أدنى مستوياتها التاريخية. صناعة السفن الأمريكية متخلفة، مخازن الأسلحة الدقيقة فارغة، وقاعدتها الصناعية غير مهيأة لحرب طويلة وشديدة. على مدى عقدين، أنفقت واشنطن مواردها على مكافحة الإرهاب، والقرصنة البحرية، والتهديدات السيبرانية، بينما كانت بكين تبني بهدوء جيشاً قادراً على هزيمة أمريكا في معركة تقليدية.
اليوم، يعترف كبار جنرالات أمريكا بأن عقيدة الردع في بلادهم في حالة انهيار. قد تتمكن الولايات المتحدة من الانتصار في حرب واحدة، لكنها ستخسر بالتأكيد في حربين أو ثلاث إذا نسّق خصومها، مثل موسكو وطهران وبكين، خطواتهم معاً. إن خطر “تآكل إمبراطوريتها” بات أكثر واقعية من أي وقت مضى. فالإمبراطوريات لا تسقط دائماً بفعل هجوم خارجي؛ أحياناً تنهار تحت وطأة عجزها الذاتي.
وامة الديون؛ إمبراطورية قائمة على السندات
على مدى سنوات طويلة، اكتسبت أمريكا نفوذها باستخدام القوة الاقتصادية. لكن تلك الصورة تتغير بسرعة. فقد تجاوزت ديون الحكومة الفدرالية 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 119٪ خلال بضع سنوات، وعلى المدى البعيد حتى 200٪؛ أرقام كانت لتُفلس أي دولة أخرى، لولا أن أمريكا هي التي تطبع عملة الاحتياط العالمي.
لكن لهذه الميزة حدودها. فإذا تزعزعت الثقة بالدولار وتوقفت الدول عن شراء السندات الأمريكية، سينهار هذا النظام؛ تماماً كما انهارت الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية مع أفول الجنيه الإسترليني وانتهاء تمويلها من مستعمراتها.
أصبح مسار إعداد الموازنة في أمريكا اليوم ليس أداة استراتيجية، بل بندولاً يتأرجح بلا حساب بين الشعبوية وانعدام الكفاءة. ومع وجود عجز بتريليونات الدولارات، تنفق واشنطن على فوائد الدين ما يقارب ميزانيتها الدفاعية. هذا لم يعد مجرد جرس إنذار، بل ورماً سرطانياً اقتصادياً. فكل دولار إضافي يُنفق على الفوائد هو دولار أقل لتحديث الجيش، أو الحفاظ على التحالفات، أو الابتكار التكنولوجي. وتزداد أمريكا شبهاً ببريطانيا ما بعد الحرب: قوة نووية تعتمد على السندات بدلاً من أدوات النفوذ الحقيقية.
وإذا سقط الدولار من مكانته كـ”عملة موثوقة”، فإن الهيكل المالي لـ”باكس أمريكانا” سيتداعى بدوره. إن سقوط الدولار لا يحتاج إلى رصاصة؛ بل هو استسلام اقتصادي صامت وهادئ، لم يعد بعيد الاحتمال.
الرسوم الجمركية والفوضى؛ النظام التجاري الجديد لترامب
تشكل الرسوم الجمركية مركز الثقل في عقيدة ترامب الاقتصادية. تحت شعار “أمريكا أولاً”، تحوّلت الولايات المتحدة من محرّك التجارة العالمية إلى كرة مدمِّرة. فقد حوّلت الحروب التجارية مع الصين والهند والاتحاد الأوروبي وحتى كندا والمكسيك، الشركاء الاقتصاديين إلى رهائن سياسية. والمشكلة ليست مجرد استياء أو تذمّر، بل إن تماسك الغرب، ذلك الكتلة التي شكّلت عمود النظام العالمي بعد الحرب، يتفكك شيئاً فشيئاً. جميع الحلفاء تحت الضغط لزيادة ميزانياتهم العسكرية، ومواجهة القيود التي تفرضها أمريكا على صادرات الفولاذ وأشباه الموصلات والأدوية والطاقة وبناء السفن والزراعة.
يقول محلل آسيوي: “الصين تهدد أمننا، لكن أمريكا تهدد مستقبلنا”. فعندما يتحول الحليف إلى تهديد اقتصادي، تتعفن جذور ذلك التحالف.
لطالما كانت الأسواق والمؤسسات الورقة الرابحة ورمز الثقة في أمريكا. فالبنك الفدرالي، ووزارة الخزانة، ووكالات الإحصاء، والقوانين التجارية، جميعها عُرفت بالثبات والعقلانية. لكن حتى هذا الحصن الأخير صار تحت الضغط. فترامب زاد من ضغطه على الاحتياطي الفدرالي، وحوّل الرسوم الجمركية إلى عصا لسياساته الخارجية. أما الخلافات حول المهاجرين، والحروب الأيديولوجية، والصراعات الشخصية بين القادة فقد زعزعت التدفقات المالية العالمية. وفي عالم تتحرك فيه الأسواق وفق المشاعر والتغريدات، تتلاشى الثقة بسرعة.
لم يعد الاقتصاد الأمريكي مرساة النظام العالمي؛ بل أصبح هو نفسه مصدراً للفوضى. والدول تبحث عن بدائل: أنظمة دفع إقليمية، اتفاقات ائتمانية، منصات استثمارية؛ وهذه البدائل يجدونها في آسيا، والبريكس، والتحالفات الإقليمية. إن “تقليص الاعتماد على الدولار” لم يصل بعد إلى مراحله القصوى، لكنه لم يعد خطوة هامشية أو ثانوية. إنه تحوّل بنيوي، وهو يتسارع يوماً بعد يوم.


نهيار القواعد وانهيار النظام
إن النظام العالمي لا يقوم على الجيوش أو الاحتياطيات النقدية، بل على القواعد. وعندما يبدأ مهندسو هذه القواعد بانتهاكها، ينهار البناء كله من الداخل.
لقد بنت أمريكا هذا النظام على أربعة أعمدة:
- حرية الملاحة البحرية
- منع الانتشار النووي
- السيادة الإقليمية
- حقوق الإنسان كقيمة عالمية
واليوم، جميع هذه الأعمدة تتعرض للهجوم.
حرية البحار؟ الصين تشدد سيطرتها على بحر الصين الجنوبي، الحوثيون يخطفون ناقلات النفط في البحر الأحمر، وروسيا تعمل على عسكرة القطب الشمالي.
المحرم النووي؟ كوريا الشمالية باتت مقبولة عملياً كقوة نووية. إيران تفصلها خطوات قليلة عن القنبلة، والصين توسّع ترسانتها.
ماذا عن السيادة الإقليمية؟ انتهكت في أوكرانيا، ومنحت الشرعية في كوسوفو، وتجاهلت في سوريا.
حقوق الإنسان؟ قائمة المآسي تمتد من الإيغور إلى غزة، وإثيوبيا، واليمن. وأما أمريكا؟ فدورها يتضاءل يوماً بعد يوم، وغالباً ما تصمت عند اللحظات الحاسمة.
لم تعد واشنطن البوصلة الأخلاقية للعالم؛ بل مجرد لاعب بمعايير مزدوجة وأولويات متقلبة، وحلفاء يزدادون تشككاً في مكانتها.
نعم، لدى دونالد ترامب إنجازات أيضاً. فقد وضع إيران تحت ضغط شديد، ووقف بلا تردد إلى جانب إسرائيل، وساعد في الحفاظ على تماسك الناتو. وإذا استمر الدعم لأوكرانيا، فسيعزز قاعدة رفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة. لكن خطاباته، وأساليبه، وروحه التصادمية تشكّل تهديداً للثوب الذي حاولت الولايات المتحدة على مدى سبعة عقود أن تخيطه كنظام عالمي.
إن أمريكا تقترب من حافة، وراءها يكمن خطر فقدان العالم؛ وربما تكون الآن بالفعل في طور عبور تلك الحافة. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان حجر الزاوية الرمزي في الاستقرار العالمي هو مبدأ “السلامة الإقليمية”، الذي فصل بين النظام وبين العودة إلى قاعدة “القوة تصنع الحق”. وقد كانت الولايات المتحدة المدافع عن هذا المبدأ؛ من اليابان بعد الحرب إلى الدبلوماسية الأوروبية السلمية في تسعينيات القرن الماضي. لكن اليوم، هذا الأساس نفسه يتزعزع بيد أمريكا ذاتها.
غالباً ما تشبه تكهنات ترامب العلنية أحلاماً إمبريالية تعود للقرن التاسع عشر أكثر مما تشبه سياسة القرن الحادي والعشرين: ضم قناة بنما، شراء غرينلاند، وحتى الاستيلاء على أجزاء من كندا؛ وهذه ليست مجرد نكات، بل إشارات إلى تحوّل عميق في النهج والتفكير السياسي الأمريكي.
وعندما يعلن نائب رئيس الولايات المتحدة، غير آبه باعتراض الدنمارك ورغبة شعبها، أن غرينلاند يمكن أن تكون “أرضاً رائعة”، فذلك ليس مجرد استهتار سياسي؛ بل إنكار واعٍ لتلك المعايير نفسها التي يقوم عليها النظام العالمي. لأنه إذا لم تعد أمريكا تحترم القوانين التي سنتها بنفسها، فما الذي يمنع الآخرين من التخلي عنها أيضاً؟
الانتحار الذاتي للنظام لأول مرة
لم يسبق لأي هيمنة عالمية أن دمرت نفسها بهدم معماريتها الخاصة. فـروما نُهبت، ونابليون هُزم على يد التحالفات، والإمبراطورية البريطانية انهارت بفعل الحرب والإرهاق. أما النظام الأمريكي، فهو لا ينهار على يد أعداء أو ثورة، بل عبر أدواته الداخلية:
- التوسع العسكري المفرط
- الاختلال المالي
- تآكل المعايير
- الفوضى السياسية
وخطاب وطني يُصوّر فيه العدوان على أنه “قوة”، ونقض العهود على أنه “استعادة العظمة”. هذا ليس مجرد اضطراب سياسي، بل انقسام بنيوي؛ إذ تتحول أمريكا، مهندس النظام العالمي، إلى حفّار قبره.
في ستينيات القرن الماضي، حذّر هنري كيسنجر من أن أمريكا ونظامها العالمي يسيران نحو الكارثة. ورغم أن ذلك لم يحدث آنذاك، إلا أن المنتقدين كثيراً ما راهنوا على انهيار أمريكا وخسروا. لكن التاريخ يقول إن الإمبراطوريات لا تسقط بخطأ واحد؛ إنما حين تتراكم الأخطاء وتصبح غير قابلة للتراجع، يأتي السقوط. واليوم، لم تعد العلامات فرضيات؛ بل حقائق واقعية، واضحة ومتسارعة. وحتى إن لم يقع الانهيار فجأة، فإن هذا التراجع قد يكون بطيئاً لكنه غير قابل للعودة.
ثلاثة مسارات لنهاية النظام الأمريكي؛ غروب "باكس أمريكانا"
كيف ينهار النظام العالمي بقيادة أمريكا؟
- المسار الأول سريع، عنيف، ولا يمكن إنكاره: كارثة عسكرية. يكفي أن تقع هزيمة في تايوان أو بحر الصين الجنوبي أو الشرق الأوسط لتبدأ سلسلة تفاعلية؛ دومينو ينهار، فيسقط البناء كله.
- المسار الثاني اقتصادي. تنهار أمريكا تحت وطأة الدين والركود والتآكل البطيء لكن المستمر لهيمنة الدولار. قوتها لا تُمحى بانفجار مفاجئ، بل عبر استنزاف تدريجي قاتل.
- المسار الثالث سياسي ومعياري. لم يعد العالم يؤمن بأمريكا. الحلفاء أصبحوا أكثر حذراً، وبدأوا يبحثون عن ضامنين بدائل.
لكن ربما السيناريو الأكثر إثارة للقلق هو أننا ننزلق الآن إلى خيار رابع، حيث تتداخل الأزمات الثلاث في عاصفة واحدة: الحملة الصليبية لترامب ضد المؤسسات، وتسليح التجارة، وأحلامه القديمة بضم الأراضي؛ لم تعد مجرد تكهنات، بل أحداث جارية الآن.
لا تسقط الإمبراطوريات كلها على النحو ذاته. فبعضها يحترق في نيران الحرب، وبعضها يغرق في بحر الديون، وأخرى تختفي بهدوء بعدما تفقد إيمانها بنفسها.
لا يزال بوسع أمريكا التراجع عن حافة الهاوية. لكن عليها أن تتذكر: الهيمنة لا تعني القوة فحسب، بل المسؤولية أيضاً. فالنظام ليس حقاً موروثاً، بل عبئاً ثقيلاً؛ وإذا تنصّلت أمريكا منه، فلن تُمنح فرصة أخرى. عليها أن تتعلم كيف تعيش في عالم لم يعد تحت سيطرتها.
إن التاريخ لا يمنح الخلود. لكنه يكرّم الذين يعرفون متى يتكيفون قبل فوات الأوان. فالعالم يكره الفراغ. وإذا تخلّت أمريكا عن دورها كحكم للعالم، فسوف يملأه آخرون
مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC)

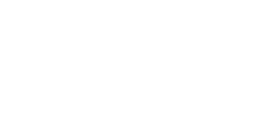






لا يوجد تعليق